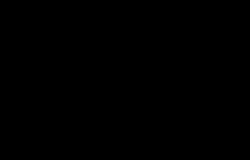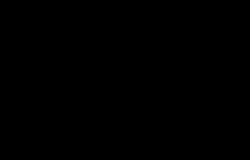اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 9 يناير 2026 06:39 مساءً تتصاعد في السنوات الأخيرة النقاشات حول لحظة التحول الحاسمة في ميزان القوى العالمي بين الولايات المتحدة والصين، وسط تنامي المؤشرات على انتقال مركز الثقل الدولي نحو شرق آسيا. غير أن هذا الجدل، رغم زخمه الإعلامي والسياسي، يتطلب قراءة معمّقة للثغرات البنيوية والاستراتيجيات المتغيّرة لدى الطرفين، بعيداً عن الانطباعات السطحية أو التصوّرات المسبقة. وهو ما يتطلّب قراءة للعلاقات الأميركية - الصينية في ضوء التحوّلات الاقتصادية والدفاعية، مع التركيز على الفجوة الهيكلية بين القوّتين، وأثر المتغيّرات الراهنة على أولويات واستراتيجيات كل طرف، واستشراف مستقبل ميزان القوى بينهما.
على الرغم من التقدّم الصيني الملحوظ في مجالات عدة، تظل الفجوة البنيوية بين الولايات المتحدة والصين عائقاً جوهرياً أمام ترجمة المكاسب التكتيكية الصينية إلى تحوّل استراتيجي شامل. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك منظومة اقتصادية هي الكبرى عالمياً، ونظاماً مالياً يهيمن على حركة رؤوس الأموال، إلى جانب شبكة تحالفات عسكرية واسعة تمدّها بعمق استراتيجي يصعب تعويضه.
على الجانب الآخر، تسجّل الصين إنجازات متسارعة في بعض القطاعات كالتكنولوجيا والنفوذ الإقليمي، لكنها تفتقر إلى تكامل القدرات على النحو الذي يسمح لها بتغيير قواعد اللعبة الدولية في الأمد المنظور. وهذا ما يمكن قراءته في الدور السياسي المهيمن الذي تلعبه واشنطن في العديد من ملفات السياسة الخارجية.
هذا التفاوت البنيوي لا يقتصر على فجوة الدخل القومي أو حجم الإنفاق الدفاعي فحسب، بل يطول أيضاً ديناميات الابتكار، ومرونة النظام السياسي، وقدرة كل طرف على امتصاص الصدمات. وبالنتيجة، تتّسم صورة المنافسة الراهنة بتركيبة معقدة: فالصين تصعّد بوتيرة لافتة، لكن الولايات المتحدة تحتفظ بأدوات ترجيح الكفة وتحصين مواقعها، ما يجعل أي تحوّل جذري في ميزان القوى عملية طويلة ومعقدة لا حدثاً فجائياً.
التكتيك العسكري الأميركييشهد الجيش الأميركي في السنوات الأخيرة تحوّلات عميقة في بنيته وتكتيكاته، مدفوعاً بضرورة الاستجابة إلى طبيعة المنافسة الجديدة مع الصين، لضمان تفوقه في أي صراع محتمل في المحيط الهادئ، وتحديداً في «سلسلة الجزر الأولى» التي تضم تايوان واليابان والفلبين.
واشنطن ما عادت تتعامل مع الصعود الصيني كظاهرة إعلامية أو سياسية، بل كتحدٍ عسكري استراتيجي يستوجب إعادة صياغة أدوات الحرب نفسها. والتدريبات الواسعة في هاواي (نوفمبر «تشرين الثاني» الماضي) لم تكن سوى مؤشر على هذا التحول؛ فبعد عقدين من حروب «مكافحة التمرّد» في العراق وأفغانستان، أظهر الجيش الأميركي استعداده لمواجهة خصم يمتلك ترسانة صاروخية ضخمة وقاعدة صناعية قادرة على دعم حرب طويلة الأمد.
التحوّل الجوهري لا يتمثل في ارتفاع حجم الإنفاق العسكري الأميركي (أكثر من 900 مليار دولار في الميزانية التي أقرّها الكونغرس أخيراً، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف الإنفاق الصيني)، بل في إعادة توجيه الإنفاق نحو أنظمة أكثر مرونة وفاعلية من حيث الكلفة. وبدلاً من الاقتصار على المنظومات المعقّدة والباهظة، بدأت القوات الأميركية تعتمد بشكل متزايد على الطائرات «المسيّرة» (المسيّرات)، وتقنيات الحرب الإلكترونية، ومنظومات قابلة للاستهلاك السريع.
وجاءت هذه المقاربة استجابة للدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا، حيث أثبتت المسيّرات الرخيصة الثمن قدرتها على تحييد أنظمة متطوّرة بملايين الدولارات.
لكن الفارق البنيوي يبقى في أن واشنطن تدير هذا التحوّل ضمن «عقيدة عسكرية» متكاملة، مدعومة بإمكانات بحثٍ وتطوير وتحالفات عالمية متينة. وفي مقابل القوة الصلبة، غالباً ما يُغفَل عنصر التحالفات عند مقارنة واشنطن ببكين. إذ إن واشنطن لا تواجه الصين منفردة، بل ضمن «شبكة تحالفات» تمتد من اليابان وكوريا الجنوبية إلى أستراليا والفلبين وأوروبا.
والتدريبات أو المناورات العسكرية في المحيط الهادئ، التي شاركت فيها قوات من تايوان وفرنسا وماليزيا، تعكس هذا البعد المتعدّد الجنسيات، الذي يصعب على الصينيين موازنته. ورغم توسّع نفوذ بكين، فإنها ما زالت في طور بناء منظومتها العسكرية الحديثة، مع افتقارها لعمق الشراكات الدولية والدعم التقني على النحو الذي تملكه واشنطن.
كذلك لا تزال قدرة بكين على بناء تحالفات عسكرية متماسكة محدودة، ولذا تعتمد غالباً على علاقات ظرفية أو شراكات غير متكافئة. وبهذا المعنى، لا يعكس التحوّل الأميركي تراجعاً بقدر ما يمثل استجابة ديناميكية لمتطلبات ساحة الصراع الجديدة.
القوة الصناعية الصينية... وحدودهاطبعاً لا يصحّ إنكار التفوّق الصناعي الصيني الذي أضحى مصدر قلق للغرب. فوفق تقديرات عسكرية غربية، باتت قدرة الصين على إنتاج كميّات من الصواريخ و«المسيّرات» تفوق قدرة الولايات المتحدة وحلفائها مجتمعين في بعض الفئات. وهذا الزخم الصناعي منح بكين هامش مناورة أوسع في التنافس العسكري والتقني، وجعلهاً لاعباً يستحيل تجاهله في معادلات الصناعات الدفاعية المتقدمة.
بيد أن هذا التفوّق يصطدم اليوم بحدود بنيوية لا تخطئها العين؛ إذ إن الاقتصاد الصيني، رغم حجمه الهائل، يواجه تحديات متفاقمة على صعيد الاستدامة والنمو. فلقد سجل الاستثمار في الأصول الثابتة تراجعاً بنسبة 1.7 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، في أول انكماش منذ أواخر الثمانينات. والأهم أن هذا التراجع طال القطاعات الثلاثة التي شكّلت لعقود محرّكات النمو الصيني، وهي: العقارات والبنية التحتية والتصنيع.
هذه المؤشرات تعكس أن القوة الصناعية الصينية ليست بمنأى عن التحديات البنيوية. إذ لم يَعُد الاستثمار، الذي كان يشكل أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، «صمام الأمان» التقليدي في أوقات التباطؤ، بينما تواصل أزمة العقارات المستمرة منذ خمس سنوات إلقاء ظلالها على الأداء الاقتصادي.
وأيضاً، تواجه الحكومات المحلية ضغوط ديون متزايدة، في حين تتراجع ثقة القطاع الخاص، ما يحدّ من قدرة بكين على إطلاق حزَم تحفيز ضخمة كما فعلت في أزمات سابقة.
واشنطن لا تواجه الصين منفردة، بل ضمن «شبكة تحالفات» تمتد من اليابان وكوريا الجنوبية إلى أستراليا والفلبين وأوروبا
تكمن إشكالية النموذج الاقتصادي الصيني في اعتماده المفرط على الاستثمار والتصنيع الموجّه للتصدير، وهذه معادلة حقّقت نتائج باهرة في مرحلة الانطلاق، لكنها تصطدم اليوم بمحدّدات الاستدامة مع نضج الاقتصاد.
والمحركات التقليدية للنمو (العقارات والبنية التحتية والتصنيع) بدأت تفقد زخمها لصالح تحديات جديدة، أبرزها تقلّص الطلب المحلي، وبطء الإنتاجية، وشيخوخة السكان. وهذا ما حذّر منه كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أخيراً، مطالبين الصين بمعالجة الضغوط الانكماشية ومصادر الضعف الداخلي، وعلى رأسها هشاشة قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي.
من جهة ثانية، تشير تقديرات مستقلة إلى أن النمو الفعلي للاقتصاد الصيني عام 2024 ربما يتراوح بين 2.4 في المائة و2.8 في المائة، أي أقل بكثير من الأهداف الرسمية التي وضعتها السلطات. وهذا الفارق ليس تقنياً بقدر ما يعكس فجوة في قراءة متانة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الصدمات. ذلك أن المخاطر الكامنة في قطاع العقارات وتضخّم الديون وتآكل ثقة المستثمرين، عوامل تنذر بتحديات قد تحدّ من قدرة الصين على مواصلة الصعود بالوتيرة السابقة ذاتها.
في المقابل، لدى الولايات المتحدة أدوات متنوعة لامتصاص الصدمات الاقتصادية، منها مرونة السوق، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وديناميكية الابتكار، ما يضفي على تفوقها الاقتصادي طابعاً بنيوياً يصعب على الصين تعويضه في المدى المنظور.
مكاسب تكتيكية في «لعبة التكنولوجيا»على الصعيدين التكنولوجي والسياسي، حقّقت بكين مكاسب تكتيكية مؤقتة، مدفوعة بـ«الدبلوماسية القائمة على الصفقات» لإدارة الرئيس دونالد ترمب، التي يبدو أنها تُعطي الأولوية للمكاسب الاقتصادية القصيرة المدى على المصالح الأمنية والاستراتيجية. ولقد تجسد هذا في قرار إدارة ترمب السماح لشركة «إنفيديا»، صانعة الرقائق الأميركية، ببيع أشباه الموصلات المتقدمة الأقل قوة (ثاني أقوى شريحة) للصين. ثم إن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للإدارة الأميركية ركّزت بشكل أكبر على المنافسة الاقتصادية بدلاً من الصراع الآيديولوجي أو الأمني. وفي سابقة منذ أكثر من 30 سنة، لم تنتقد الوثيقة الحكم الاستبدادي الصيني أو تضغط من أجل حقوق الإنسان.
هذه التنازلات عزّزت سردية بكين القائلة إن «الصعود التكنولوجي الصيني لا يمكن إيقافه» وإن واشنطن «لا تستطيع تحمل تكاليف المواجهة المطولة» مع الصين. فعندما وافقت واشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية بعدما لوّحت بكين بورقة حجب صادرات العناصر الأرضية النادرة والمواد الحيوية الأخرى، بدت وكأنها تستجيب لـ«الابتزاز» الاقتصادي. لكن المحللين يشيرون إلى أن هذا التراجع قد يكون مجرد استراتيجية أميركية مؤقتة لإعادة التجمع وبناء القوة.
كذلك يرى آخرون أن ترمب قد يكون يستلهم مقولة الزعيم الصيني دينغ شياوبينغ «اخفِ قوتك وتريّث»، حيث تُركز واشنطن على إعادة بناء تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي المستقبلي. وجوهرياً، يظل الهدف الأميركي، وفقاً لهذه التفسيرات، الحفاظ على الوضع المهيمن ومنع واحتواء صعود الصين.
لقد فرضت التحولات البنيوية في القدرات الاقتصادية والعسكرية لكل من الولايات المتحدة والصين إعادة رسم الاستراتيجيات الإقليمية والدولية.
وتسعى واشنطن إلى تعميق تحالفاتها في آسيا والمحيط الهادئ، وتكثيف التعاون الدفاعي مع الحلفاء التقليديين (اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا)، مع التركيز على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وردع أي مغامرات صينية تهدد الوضع القائم. وفي الوقت عينه، تواصل الاستثمار في الابتكار التكنولوجي والبحث العلمي، بوصفهما رافعتين أساسيتين للحفاظ على تفوقها النوعي.
أما الصين، فتركز على تعزيز حضورها الإقليمي عبر مبادرة «الحزام والطريق»، وتوسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. لكن محدودية التحالفات العسكرية والتحديات الاقتصادية الداخلية، تفرض عليها انتهاج سياسة خارجية أكثر حذراً، والسعي لتقليص الاعتماد المُفرط على الأسواق الغربية، وتطوير منظومات تكنولوجية وطنية.
في هذا السياق، لا تقتصر المنافسة على الجانب العسكري أو الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى ميادين الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات، والطاقة الخضراء، ما يؤشر إلى تعددية ساحات الصراع وتشابكها. ومن ثمّ، تبقى قدرة كل طرف على التكيّف مع هذه التحولات، وإعادة صياغة أولوياته، العامل الحاسم في ترجيح كفة ميزان القوى مستقبلاً.
مستقبل ميزان القوىالاستنتاج الأبرز من المشهد الراهن أن الصراع الأميركي – الصيني لم يصل بعد إلى لحظة الحسم، ولا يبدو قريباً منها.
الصين تحقق تقدماً ملموساً في بعض المجالات، وتستفيد أحياناً من تردد أو براغماتية أميركية. لكنها في المقابل تواجه تباطؤاً اقتصادياً داخلياً، وتحديات ديموغرافية، وبيئة دولية أكثر حذراً تجاه صعودها.
ومع أن الصين تحقّق مكاسب تكتيكية في بعض القطاعات وتستفيد من ديناميات الاقتصاد العالمي، يبقى التفوق الأميركي قائماً على منظومة متكاملة من القدرات والموارد والتحالفات. وواشنطن، رغم الاستقطاب الداخلي والضغوط المالية، لا تزال تمتلك مزيجاً نادراً من القوة العسكرية، والعمق الاقتصادي، والتفوّق التكنولوجي، وشبكة التحالفات. وهذا مزيج يجعل الكلام عن «أفول أميركي وشيك» أقرب إلى التبسيط الإعلامي منه إلى التحليل الاستراتيجي الرصين.
وفي المحصلة، قد تكون الصين صاعدة، وقد تكون الولايات المتحدة أقل ثقة مما كانت عليه قبل عقدين، لكن ميزان القوى لا يُقاس بلحظة واحدة. وفي هذا الميزان، لا يزال التفوق الأميركي، حتى إشعار آخر، حقيقة يصعب تجاوزها.
الجيش الأميركي يتأهب لـ«حرب مُرعبة» في المحيط الهادئ> نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تقريراً عن تحضيرات يجريها الجيش الأميركي لمواجهة الصين، ويشير إلى أنه رغم امتلاك بكين إحدى أكبر ترسانات الصواريخ في العالم وقوة صناعية لا مثيل لها لدعم قواتها في حرب طويلة الأمد، فإن الولايات المتحدة تُجري تحوّلاً جذرياً في عقيدتها التكتيكية لضمان تفوقها في أي صراع محتمل في المحيط الهادئ، وبخاصة، في تايوان. الجيش الأميركي يتأهب، لما سماه التقرير «عصر حرب مُروِّع» يتميز بالاعتماد على التكنولوجيا الرخيصة والمستهلكة، على رأسها «المسيّرات». وهذا التحوّل اضطرت إليه واشنطن لمواكبة الدروس المستفادة من ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث تسيطر أنظمة «المسيّرات» على الميدان. وتشمل أشكال التأهب: • تغيير الأدوات والتكتيكات، حيث تبنى الجيش الأميركي بسرعة تكنولوجيا وتكتيكات جديدة، عبر تعويض المعدات القتالية التقليدية والمكلفة بأنظمة رشيقة ورخيصة نسبياً. • «المسيّرات» التي بدأ العسكريون الأميركيون يتدرّبون على أنظمة متعدّدة منها، حيث انتقلت فرق المشاة من نوع واحد إلى 7 أنواع خلال سنة واحدة تقريباً. وكذلك نفَّذ العسكريون أكثر من 600 طلعة جوية بـ«المسيّرات» خلال تدريبات نوفمبر (تشرين الثاني) في جزيرة هاواي وحدها. • القدرة الهجومية؛ إذ يجري التركيز على «المسيّرات الهجومية الانتحارية» التي تُصنَّع هياكلها محلياً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما يجري تطوير أسلحة جديدة للكشف عن «المسيّرات» المعادية وإعاقتها أو تشويشها باستخدام ما تُعرف بـ«السهام الكهرومغناطيسية». • الحرب الإلكترونية، التي أصبح مجالها الذي يتعامل مع الموجات والإشارات الخفية، أكثر أهمية من أي وقت مضى. والهدف هو العثور على مشغّلي «المسيّرات» المعادية وقتلهم عبر الكشف عن الإشارات التي تُصدرها أجهزتهم. مع كل ما سبق، تُعد القدرة الصناعية على الإنتاج الضخم نقطة تفوّق حرجة للصين. إذ بينما تُنتج أوكرانيا وروسيا ملايين «المسيّرات» سنوياً، بإمكان الصين التفوّق على إنتاجهما معاً.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير